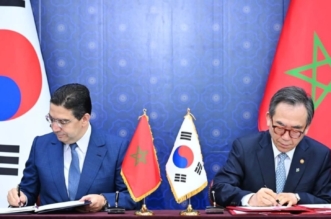ياسين عدنان
تلقّيتُ باندهاش تفاعلًا متشنّجًا على إثر استضافتي للكاتبة المغربية المقيمة في كندا الدكتورة لطيفة حليم يحمل توقيع شاعر مقيم بكندا هو الآخر يدعى هشام فهمي. والحقيقة أنني لم أكن أعلم قبل تسجيل الحلقة أنّ صاحبنا قد حفّظ كندا في السجل العقاري باسمه، لكي لا يجرؤ أحدٌ على الدّنُوِّ من حياضها إلا بترخيص مسبق من خِفَارَته. كما لم أتصوّر قطّ أنّ الرجل -الذي كان صديقًا ذات يوم- يحمل لي في نفسه كل هذا الغلّ. فالذين ابتلاهم الله بقراءة ما كتب، لاشك أشفقوا عليه. رغم أنّني أحمد الله على أنه تقيّأ كل ذلك الصّديد، فلو ظل يكتمه في صدره لأهلكه.
لقد كان “مشارف” منذ بداياته منفتحًا على أدباء الدياسبورا المغربية باعتبارهم جزءًا لا يتجزّأ من نسيجنا الثقافي والأدبي. واستضَفْنا، في هذا الإطار، عددًا من أدبائنا المقيمين بفرنسا مثل الطاهر بنجلون وعبد اللطيف اللعبي ومحمد حمودان وحنان درقاوي وغيرهم، إلى جانب أسماء أدبية وفكرية أخرى من ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا. كما سعيتُ منذ مدة إلى استضافة اسم أدبي من كندا التي استقطبَتْ في السنوات الأخيرة نخبةً من المبدعين المغاربة، لكن الأمر تعذّر لأسباب لوجستيكية ليس هذا مقام الخوض فيها. لذلك، ما إن أخبرَتْني لطيفة حليم بأنها ستكون في المغرب خلال عطلة الصيف الماضي، حتى رحّبتُ بها بلا تردّد، دون أن أتصوّر للحظة أنني سأرتكب بهذه الاستضافة “كبيرة الكبائر”.
لست في حاجة إلى التأكيد على أنه لا تجمعني بالدكتورة حليم أية معرفة شخصية سابقة. وقد كان يوم تصوير حلقة “مشارف” لقائي اليتيم معها. جاءت السيدة لتتحدّث عن تجربتها مع الكتابة بشكل عام، ثم من داخل الشرط الكندي تحديدًا. كانت لطيفة حليم قد بعثَتْ لي روايتَيْها (دنيا جات) و(نهاران). ولقد قادَتْني البداهة فور استلامي لـ(دنيا جات) إلى التفكير في رواية (دنيا زاد) للصديقة مي التلمساني، التي سبق أن استضفتُها في “مشارف”، لكن من حسنات القراءة أنها تقودنا إلى تجاوز أسئلة البداهة العمياء التي يحرن عندها هواة لوْكِ العناوين. لذا ذهبتُ في الإعداد أبعد قليلا من العقبة الذي وقف عندها حمار صاحبنا وهو يقترح عليَّ سؤاله المضحك. هكذا جاءت أسئلتي للطيفة حليم، صريحةً دونما تجاسُر، نقديةً دونما تحامل. لم أداهن ضيفتي ولم أسايِرْها، وأغلبُ التحفّظات التي ساقها صاحبنا في مقالته المتنطّعة على بعض أجوبتها نقلها منّي، ذاك أنّي واجَهْتُها بها في حينه، والحلقة مبذولةٌ على اليوتوب لمن أراد التأكّد. لكنّني فعلتُ بدون استعلاء ولا استعراض، ودونما تواقُح.
ولكم صُدِمْتُ وأنا أقرأ هشام فهمي يعترض على استضافة لطيفة حليم لأنّها سيّدة “مُسِنّة”. هل ما زال بيننا من يُعيِّر الناس بأعمارهم، وكأنّ التقدّم في السن جريمة؟ وحشدًا للدلائل على اعتراضه الجاهل يضيف الشاعر الفهمان بأنّه “لم يسمع عنها من قبل”. يبدو أن السمع بالأدباء أهمّ عند أخينا من القراءة لهم. وأخشى فقط لو اعتمدتُ هذا الشرط لاستضافة الأدباء في “مشارف” لما تجاوز البرنامج سنته الثانية. قبل أن يسوق الفهمان حُجّته الدامغة التي تُسوِّغ غضبته المُضَرية على ضيفة البرنامج، وهي أنها “تلفُّ رأسها على طريقة خالتي منّانة”، ولَكُم أن تقدّروا بأنفسكم منسوب البذاءة وقلة اللياقة في هذا الكلام. لقد استقبلتُ في مشارف سيّدات محتجبات، وأُخَر محتشمات، وأخريات بأزياء متفتّحة. كنت أذهب معهن مباشرة إلى الجوهر -نقاش الفكرة والرأي والموقف- ولم يحدث قطّ أن انشغلتُ بأمور الهندام. بل أستغرب كيف تصدر هذه الملاحظة البذيئة عن شخص يعيش في بلد قائم على احترام الحرية الشخصية. “أولئك كالأنعام بل هم أضلّ”.
لم يدَّع صاحب “مشارف” أنه قاطرةٌ للثقافة الطليعية في بلادنا لكي يرفع البعض السقف عاليًا أمامه. إنما أنا معدُّ برنامج ثقافي من فئة 26 دقيقة تقدّمه قناة عمومية خارج وقت الذروة. ومع ذلك نجتهد لنرهن أغلب حلقات البرنامج بأسئلة فكرية وثقافية نؤطّر بها نقاشاته بعيدا عن الهذر السائب والثرثرة الفارغة. مثلما ننوِّع في الضيوف لخلق بعضِ الدينامية وضمان الإحاطة بمختلف مجالات الفكر والثقافة والفن. لا نضمنُ نجاح كل الحلقات ولا تألّق جميع الضيوف. لكن، جرت العادة أنه ما إن يلمس فاعل ثقافي معنيٌّ بالموضوع ضعفًا في الحلقة، إمّا لأنّ المنشّط لم يُوفِ الموضوع حقّه من الإعداد أو بسبب قصور الضيف، حتى يكتب منتقدًا ما يراه جديرا بالانتقاد، قبل أن يمر إلى ملء الفراغات التي تركَتْها الحلقة ورصد ما حوَتْ من مغالطات محتملة. هكذا تُمارَس الرقابة على البرنامج، ويتبلور النقاش العمومي، وتعمّ الفائدة. أمّا أن يتخيّل أحدهم نفسه فوق الضيف والمُضيف والنقاش ومغاربة الداخل والخارج وكندا والموزمبيق، فهذا ضربٌ من العَته لا يليق.
وإذا كان الدكتور فهمان قد أخذ علينا أن قدّمنا ضيفة البرنامج باعتبارها “أديبة” رغم أنها لم تُصدر سوى روايتَيْن، فليعرّفنا بما قدّم هو للأدب؟ ومع ذلك نشغل نفسنا بالردّ عليه ليس اعتبارًا له، وإنما احترامًا لمن قد تُشوّش عليهم تُرّهاته من القرّاء والأصدقاء.
ثمّ إنّ توصيفَ الأديبِ ليس وسامًا. فالأديب هو المشتغل بالأدب، مثلما يقرع الحدّاد الحديد ويُباشر النجار الخشب. ومثلما يجد الحداد والنجار أمامهما ألفَ من يُثمِّن نتيجة عملهما، للقرّاء والنقّاد أن يقيّموا إنتاج هذا الكاتب أو ذاك، جيّدًا كان أم رديئًا. أما أن نخرج على الناس عبر شقلبات بهلوانية على الانترنت لنصادر حقهم في الانتماء إلى مجال الأدب دونما احتكامٍ للنّقد ومعاييره، ودونما حاجة إلى قراءتهم أصلًا، فهذه فَتْوَنَةٌ لا تثير سوى الاستهجان.
هذا عن الضيف، فماذا عن المُضيف؟ أنا من كتّاب هذا البلد الذين يجرّبون بحرّيةٍ المُراوحة بين القصيدة والقصة والرواية. وليعذرنا الشاعر “النّقيُّ” إذا كنّا قد اقتحمنا مجال الرواية دون ترخيص منه مثلما اقتحمنا عليه خلوته الكندية بلا استئذان. لعلّي ارتكبت بذلك جنايةً هاأنذا أؤدّي ثمنها اليوم. فكل ما كتبتُه باطل، حتى دون أن يقرأه فهيمنا. إذ لا وقت لدى الكاتب الطليعيّ الحرّ لقراءة خزعبلاتنا. تكفيه نوايانا التي قدّر فسادها، ليحكم بأنّ كلّ ما ننتجه من أدبٍ باطلٌ حتى ولو قمنا بدورة شرفية على كل الأجناس الأدبية على حدّ تخريفه.
لكن، ما هي الإهانة العظمى التي لحقت الرجل منّا فأفقدَتْه صوابه؟ ببساطة، ذكرتُ اسمه في البرنامج ضمن لائحة من الكتّاب المغاربة المقيمين بكندا. هذا كل ذنبي. أم ربما ضايقَتْه إشارتي للشاعر مصطفى فهمي؟ لعلّه خوصَص لقب “فهمي” أيضًا بعدما حفّظَ كندا باسمه؟ مع العلم أن دردشة عابرة قُبَيْل التسجيل مع الضيفة تحدّثنا فيها عن تألق مصطفى فهمي في مجال الدراسات الشكسبيرية هو ما شجّعني على التوقف قليلا عنده. فما العيبُ فيما أتيت؟
الحقيقة أنني ندمت ندامة الكُسَعي أنْ ذكرتُ اسم هشام فهمي في تلك الحلقة. أعرف أن هناك أسماء حُسنى خصّ بها العلي القدير نفسه وهي جديرة بالتّوقير، وهناك اسم عربي جريح والعهدة على الخطيبي، لكن لم يخطر ببالي قطّ أن هناك اسمًا دُمَلًا ما إن تلمسه، ولو لِنَفْضِ الغبار عنه، حتى يفزّ قيحه فينالك منه الأذى والصديد.
ثم إن الأدب غير قلّة الأدب. أتفهّم أن يحتاج المبدع مزاجَه الخاسر أحيانًا للكتابة. لكن الأدب يحتاج أيضًا إلى خيالٍ وخبرةٍ روحية ودأب واشتغال ومثابرة، ثمّ إلى قليل من التواضع أمام تجارب الآخرين. مشكلة فهمي هي أن الشقلبات التي جعلتنا نتوسّم فيه خيرًا ونحن نقرأ نصوصه الأولى في بداية التسعينيات ظلّت مبلغ همِّه ومُنتهى مُنجَزِه، وليس أقسى على الكاتب من أن ترهَن بداياتُه أفُقَه. وهنا أشفق عليه صِدقًا. إذ فيما واصل أقرانه التجريب والبحث والحوار مع الذات والآخرين، اعتلى هو برج أوهامه وطفق ينظر إلى المشهد الأدبي من عَلٍ فيرى الجميع أقزامًا، دون أن ينتبه إلى أن لا أحد يراه أصلًا. ليس لأنهم عميان كما وصفهم في مقاله الرّكيك، ولا لأنّهم توافَقوا على تجاهله كما صوَّرت له وساوسه، ولكن ببساطةٍ لأنه غير موجود. فالكاتب يتحقّق عبر تراكم منجزه الإبداعي. وهو ما نجح فيه عددٌ لا بأس به من أترابه، ومن أدباء الجيل اللاحق، وهذا بالضبط ما فشل فيه صاحبنا رغم فائض الادّعاء. ولم يبق أمامه إلّا استثمار أعراض البارانويا في إنتاج مقالات قليلة الأدب يشهرها من حين لآخر عبر خرجات بذيئة متشنّجة بغية لفت الانتباه إلى أناه المتقرّحة.
أما دَوْر “سنفور غضبان” التراجيكوميدي الذي لا يملك غيره، فربما كان مفهوما في زمن البدايات الذي غادَرْناه جميعًا، إلّا أنه لم يعد مقبولا اليوم. ثم إن قليلا من النّضج لا يقتل.
قلتُ إننا غادَرْنا زمن البدايات، دون أن يعني ذلك أننا تنكَّرْنا لعنفوانه. وصديقنا الذي يعيِّرنا بالاشتغال في “دار البريهي” هدفُه التعريض. وإلّا، فالعبرة بالحصيلة وبمدى نجاحنا، أو فشلنا، في ضمان الحدّ الأدنى من الجدّية في طرح السؤال الثقافي، والمسؤولية في التفاعل مع قلق الأدباء والمبدعين والمفكّرين المغاربة من مختلف الأجيال والحساسيات. لكن، لا يمكن للشاعر الطليعي أن يبدِّد وقته الثمين في مشاهدة برامج “دار البريهي” ليحكُم عن مُتابَعة. فهو يعرف مسبقًا أنها “رديئة”، وحكمُهُ عليها جاهزٌ بإطلاق، نافذٌ لا يقبل الاستئناف ولا المراجعة. ثم ما حاجة صاحبنا للاهتمام ببرامج تافهة لا تصرف تعويضًا ماليًّا لضيوفها؟ فرِحَالُ الشاعر الطّليعي لا تُشدُّ لأقلّ مِن (مَن يربح المليون؟) الذي سبق له أن شارك فيه مجيبًا -مثل تلميذٍ مشكوكٍ في نجابته- على أسئلة البرنامج “العميقة” “بالغة الجدّية”. والأدهى، أنّه أقصي من المسابقة في مرحلتها الأولى، وهي مرحلة لا تُبثُّ على الشاشة لحسن الحظّ. هذه هي برامج الدكتور فهمان المفضّلة، والتي لا تجوز مقارنتها ببرامجنا الثقافية “البئيسة”.
يدرك صاحبنا جيّدا صعوبة أن تشتغل في التلفزيون الرسمي لبلدك، وتحافظ في الآن ذاته على استقلاليتك ككاتب وفاعل ثقافي. إنها “صعوبة الوطن” التي تحدّث عنها جمال المعتصم بالله في إحدى قصائده الجميلة. ولأنك لا تملك وطنا آخر غيره، فإنك تكابد هذه الصعوبة الجميلة بحماسة وشغف متحمّلا كل التبعات دون بطولة زائفة ولا مزايدة متبجّحة. ولعل الشاعر الطليعي يراقب كلَّ ما يصدر عنك من مواقف كلما جَدَّ الجدّ، ولعله تابع حتى بعض ما تعرّضْتَ له من مضايقات، لكنه كامنٌ في مقبعه مثل أفعى عمياء كل ما تُجيده هو التربُّص المتأهِّبُ للّذغ. يراقب عن كثب. يتشفّى في صمت حين يستدعي الأمر التشفّي. واليوم ببهلوانيته العجيبة يأتي ليُتَفّه كلّ شيء. ولأن الاختزال الفجّ مهنة البُلداء، فالرجل يلخّصُ الحكاية كلها في “ازدواجيةٍ” لا يمكن أن تنطلي على “نباهته”. هكذا يختزل فهيمنا ما لا يُختَزل. يفعل بقدرةٍ على التلفيق يُحْسَد عليها.
يبدو أن هناك صنفًا من الناس تعيش معهم، تنشر كتاباتك بينهم، تعبّر عن مواقفك في منابرَ متاحةٍ لاطّلاعهم، لكنهم على الدّوام، أذنٌ من طين وأخرى من عجين. بعيدون كل البعد عن ثقافة الاعتراف التي تجعلهم يقدّرون مجهودات الناس ويتفاعلون معها بمحبة. فيما ثقافة التلصُّص المتمكنة من نفوسهم المريضة تجعلهم يخنسون مترقّبين الكبوة لكي ينخرطوا في العويل. لا يغادرون جحورهم إلا حينما يرونك تتعثّر. حينها، يُطلّون برؤوسهم لا لينتقدوك بنبالة، ولا ليقوِّمُوا أخطاءك بحزم، بل لكي ينفثوا في وجهك سموم حقدهم بلغةٍ هي إلى مياه المجاري أقرب منها إلى شيء آخر.
سبق لهشام فهمي أن جرّب الاشتغال في مجال الصحافة الثقافية في هذا البلد، ومن إنجازاته الشهيرة أن نشر لأحد الشعراء -بُعَيْد وفاته- رسالةً يحكي فيها الرّاحل كيف كانت أمه العجوز تفتح رجليها في مقبرةٍ للعابرين بمقابل، لكي يأكل هو ويشتري خبزا وسجائر وأقلاما. كان الرّاحل مريضا نفسيا، فلم يُراعِ صاحبنا هشاشته النفسية قيد حياته، ولا حُرْمَة وفاته. الكثيرون تألموا يومها. لكنني كنتُ أشفق على المحرّر الثقافي الفاشل الذي صنَّف كتّابَ البلد – بلُغَتِه الشمهروشية الركيكة -إلى شحابيط، وخرابيط، وهلمّ لخبطة. قاطع أغلبَهم أو قاطعوه، ثمّ جلس مثل بومة على خراب “مُلحَقِه” يتربّص بالجثث. وحينما أوقفَتْه إدارة الجريدة -أو استقال منها سيّان- بسبب أدائه السيّئ على الأرجح، كتب الشاعر الطليعي على صفحته الفيسبوكية: “سأنشر بيان استقالتي يوم الاثنين. سأشرح فيه نوع الإهانة التي تعرّضتُ لها من مدير الجريدة”.
حدث ذلك في مارس 2013، فكَمْ من اثنين مرّ على ذلك الاثنين؟ لكنّ الرِّعديد الذي ابتلع الإساءة، ومعها لسانَهُ، ولم يفصح حتى الساعة عن طبيعة الإهانة التي تعرّض لها حينئذ، سيشرب حليب السباع فجأةً، وهاهو “يزأر” فقط لأننا ذكَرْنا اسمه عرَضًا، بتلقائية وحسن نية، في “مشارف” كأحد الشعراء المغاربة المقيمين في كندا. فجاء ردُّه الفظّ بعد أسبوعين فقط من بثّ الحلقة.
فهل كان لمجرّد ذكر اسمك، يا باسل، في “مشارف” وقعٌ أشدّ من الإهانة السرّية التي حكَيْتَ عنها في مارس 2013؟ أم كان كأسك مترعًا بما لا علم لنا به ولا يد لنا فيه، فكانت التفاتَتُنا البريئة إليك القطرة التي أفاضت النحس؟ فحتى قطرة المطر الزّلال قد تُفيض كأس المرارات. لكن ما بالك ركَنْت كأسك المُرَّة جانبًا وطفقت تبول على قطرةٍ صديقةٍ أيّها الفهيم؟
وختامًا، هل أدلّكم على تجارة تُكسبكم بدل المليون عشرةً دونما حاجة إلى المشاركة في البرنامج إيّاه؟ يكفي أن يشتري الواحد السنفور المغرور بقيمته الحقيقية، ويجد مغفّلا يبتاعُه منه بالثمن الذي يتخيّل نفسه يستحقّ ليكسب بدل المليون ملايين. أمّا نحن، فلسنا ممن يُقعقَعُ لهم بالشِّنان أو يُجفِلهم تنطّطُ سنفور غضبان. ثمّ إنّه “ليس أسهل من إتيان الشر، فالكل قادرٌ عليه”، رحم الله سيوران.