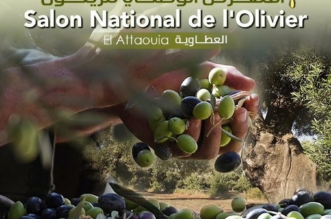بقلم : كريمة قروان / باحثة في سوسيولوجيا المخاطر و التحولات المجتمعية.
Abstract
Drawing on risk sociology, this theoretical study reexamines how pedagogical authority functions within digital and asynchronous educational settings, arguing that online environments fragment the unified temporal structure, which historically constituted “pedagogical time”, that traditionally anchored classroom discipline and institutional credibility. Unlike conventional face-to-face instruction, where authority operates through immediate, co-present interactions, digital platforms transform authority into a negotiated, asymmetrical, and provisional dynamic often deferred across technological interfaces and time delays. The analysis identifies four interconnected processes reshaping this authority: the fragmentation of classroom temporal rhythms exposing teachers to asynchronous vulnerability; the weakening of conventional legitimacy as competing platform logics intrude; a fundamental transition from disciplinary control toward adaptive management of dispersed interactions; and the rising primacy of symbolic influence over direct command. Evidence from Moroccan educational contexts, spanning hybrid and fully remote formats, demonstrates how asynchronous participation patterns, algorithm-driven visibility mechanisms, and the emergence of rival “platform authorities” fundamentally reconfigure teacher-student relationships, rendering authority structurally unstable. The proposed framework reimagines effective pedagogy not as exerting control but as cultivating negotiated, context-responsive influence through rebuilding trust, sustaining shared meaning, and coordinating learning across fragmented timescales. Practical implications for educators and policymakers include designing instruction around temporal flexibility, developing skills in communicative negotiation, and establishing legitimacy independent of physical co-presence, offering concrete strategies for navigating technology-mediated teaching environments.
Keywords: educational authority; pedagogical temporality; asynchronous learning; symbolic legitimacy; Moroccan school.
ملخص
يسعى هذا المقال إلى تقديم تأصيل نظري جديد لمفهوم السلطة التربوية في ضوء التحولات الجذرية التي أحدثتها الرقمنة داخل الفضاء المدرس ي، وذلك من خلال توظيف الأدوات التحليلية لسوسيولوجيا المخاطر. ينطلق التحليل من فرضية مفادها أن البيئة الرقمية، بما تحمله من تنوع في الإيقاعات وتعدد في المرجعيات، قد أفرزت نمطًا جديدًا من السلطة، لم تعد تُمارس بشكل مباشر أو متزامن، بل أصبحت سلطة تفاوضية، غير متوازنة، تشتغل ضمن شروط لا يقينية. يعالج المقال مظاهر الانكشاف الزمني، تآكل الإيقاع التربوي، انهيار الشرعية التقليدية، والتحول من الانضباط إلى التكيّف. كما يقترح نموذجًا مفاهيميًا للسلطة التربوية المعاصرة، يستبدل منطق السيطرة بإمكانيات التأثير الرمزي، ويعيد النظر في مقومات المشروعية داخل فضاء معرفي موقوت بالمخاطر.
الكلمات المفتاحية: السلطة التربوية، الزمن البيداغوجي، التعلم غير المتزامن، الشرعية الرمزية، المدرسة المغربية.
مقدمة
يكشف التوسعُ الرقمي غير المنضبط تحوّلًا بنيويًا في العلاقة التربوية، إذ ينتقل الفعل التعليمي من إيقاع حضوري متزامن إلى بيئات غير متزامنة تتوسّطها المنصّات والخوارزميات. وتفقد الشرعية المدرسية اعتمادها الحصري على الحضور الجسدي وتراتب الهيبة المعرفية، لتُقا س بقدرة المدرّس على التكيّف مع إيقاعات زمنية متشظية ومنطق تقييم شبه خوارزمي يغلّب سرعة الاستجابة وتواتر التفاعل على عمق المعالجة. وتتقاطع هنا مرجعيتان: بيداغوجية تقليدية وأخرى رقمية أذاتية، بما يجعل التقنين وحده عاجزًا عن الضبط. وتقدّم سوسيولوجيا المخاطر إطارًا لقراءة هشاشة المؤسسة وتفكّك الإيقاعات الاجتماعية وصعود أشكال خفية من المراقبة والمخاطر الرمزية تدفع بأدوار تنفيذية تُضعف سلطة التأطير وبيداغوجيا الحوار.
ويبرز في السياق المغربي تعاقبُ صيغٍ انتقالية -من التعلّم عن بُعد إلى التناوب ثم إدماج أوسع للوسائط )مثل «مدارس الريادة»( – بما ينفي وجود نموذج رقمي موحّد ويستدعي مساءلة مفاهيم: السلطة التربوية، الزمن البيداغوجي، الشرعية الرمزية، والتنظيم اللامتزامن للتعلّم. وينطلق التحليل من فرضيةٍ مركزية مؤدّاها أنّ ممارسة السلطة لم تعدرهينة التحكم في الحضور والزمن بقدر ما تستند إلى التفاعل الرمزي في فضاء موسوم باللايقين البنيوي، مقترحًا أربعة محاور مترابطة: تموضع المدرسة في «مجتمع المخاطر»، أثر «انفجار الزمن الرقمي» على السلطة الصفّية، إمكانات «التفاوض البيداغوجي» بديلًا عن الانضباط الكلاسيكي، وتأصيل «سلطة تربوية متك يفة» توفّق بين المرونة الديداكتيكية وحفظ الأدوار الرمزية للمربي.
1- تفكك الإيقاع التربوي في مجتمع المخاطر: بين الانكشاف الزمني وتصدع الشرعية
يُعدّ التحول الرقمي الذي يشهده المجال التربوي اليوم مدخلًا لإعادة النظر في موقع المدرسة كجهاز منظم للزمن البيداغوجي، وموجه للعلاقات الرمزية داخل الفضاء المدرس ي. ففي سياق يتّسم بتعدد مصادر التأثير، وتفكك الإيقاعات التعليمية، لم تعد المدرسة – لا سيما في السياق المغربي – تشتغل داخل بيئة قابلة للضبط الزمني والمعياري، بل وجدت نفسها منفتحة على فضاءات رقمية غير متزامنة، تخترق الحدود التقليدية للفعل التربو ي.
يندرج هذا المحور ضمن محاولة سوسيولوجية لتحليل تآكل منطق “الإيقاع التربوي الموحد”، الذي كان يشكل لبنة أساسية في ضبط الزمن المدرس ي، وفي تثبيت سلطة الأستاذ. كما يسائل مدى قدرة السلطة التربوية على الحفاظ على شرعيتها الرمزية ضمن فضاءات متشعبة، غير منضبطة، يَصعب فيها التحكم في وتيرة التلقي، ومصادر المعرفة، وأنماط الحضور.
1-1 المدرسة كمؤسسة مكشوفة داخل بيئة رقمية غير قابلة للضبط
في قلب ما يُعرف في أدبيات علم الاجتماع الحديث بـ”مجتمع المخاطر”، كما نظّر له أولريش بيك، لم تعد المدرسة تؤدي وظائفها التربوية من داخل موقع مستقر ومؤطّر بنسق زمني موحّد، بل أصبحت فاعلًا تربويًا مكشوفًا ضمن بيئة رقمية تتسم بالتقلب، وبتعدد الإيقاعات، وبصعوبة الضبط والتوقع. لقد فقدت المؤسسة التربوية، تدريجيًا، امتيازها التاريخي في تنظيم الزمن التعليمي، وهو الامتياز الذي كان يُشكّل أحد مصادر سلطتها الرمزية في النموذج الصناعي للمدرسة، حيث كان التحكم في التوقيت وتدبير الزمن البيداغوجي يؤسس لمشروعية فعلها التربوي.
أما اليوم، في ظل ما تُنتجه الرقمنة من تنوع في أنماط الحضور والتلقي، وتفكك في الإيقاع التربوي الموحد، يجد الفاعل التربوي نفسه في وضعية ارتباك مستمر، إذ لم يعد الزمن مجرد أداة تنظي مية بيد المؤسسة، بل أصبح مكوّنًا مفتوحًا، مرنًا، متشظيًا، يُعاد تشكيله من خارج فضاء القسم. وهكذا تتحول السلطة التربوية من سلطة ضابطة إلى سلطة معرضة للانكشاف، لا فقط من حيث فقدان التحكم الزمني، بل أيضًا من حيث اهتزاز موقعها الرمزي داخل بيئة معرفية مفتوحة تتعدد فيها مصادر التأثير وتتداخل فيها المرجعيات.
لا يقتصر الانكشاف التربوي، في سياق الرقمنة، على فقدان السيطرة المؤسسية على الفعل التربوي، بل يتعداه إلى ما يمكن تسميته بـ”تفكك الإيقاع الضامن للشرعية”.
فحين يعجز النظام التربوي عن توحيد التجربة الزمنية للتعلّم – أي عندما لا يعود الزمن البيداغوجي خاضعًا لمنطق مشترك بين الفاعلين – تتعرض بالضرورة شرعية السلطة القائمة على قيم الانضباط، والتدرج، والاستمرارية إلى التآكل التدريجي.
وتتمثل المفارقة الجوهرية هنا في أن المؤسسة التعليمية، بينما تطمح إلى تحقيق نجاعة رقمية عبر المنصات والوسائط التفاعلية، تجد نفسها في مواجهة بنية رقمية غير قابلة للضبط الكلي، تُنتج أنماطًا جديدة من الحضور التربوي غير التقليدي: كالغياب المقنّع، أو الحضور الصامت، أو الانخراط المؤجل، وهي كلها ممارسات تُعيد تشكيل مفهوم التفاعل التربوي نفسه.
وضمن هذا المشهد الزمني المتشظي، يصبح الفعل التربوي موزعًا بين أزمنة متقاطعة، يصعب معها الحفاظ على وحدة الإيقاع، وعلى فعالية التعلم بالشكل الذي كانت تضبطه الهندسة البيداغوجية التقليدية. وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول كيفية إعادة بناء الفعل التكويني داخل سياقات لم تعد تقوم على التزامن ولا على الحضور المتجانس، بل على أنماط متباينة من التفاعل تتطلب نماذج جديدة للفهم والتنظيم.
إن سوسيولوجيا المخاطر، بما تحمله من مفاهيم حول اللايقين المؤسساتي والمخاطر غير المحسوسة، تُوفر الإطار الأمثل لفهم هذا التحول. فالمدرسة لم تعد معرضة لمخاطر خارجية قابلة للقياس، بل باتت تنتج ذاتيًا نوعًا من “الخلل الزمني الممَُأسس”، حيثلا يتم ضبط الإيقاع البيداغوجي من داخل المؤسسة، بل يُعاد تشكيله باستمرار من خلال تدفقات رقمية لا تخضع لمنطقها الداخلي. وهو ما يتجلى بوضوح في تجارب التعليم عن بعد، حيث يفقد الزمن التعليمي طابعه التعاقدي، ويصبح كل من المدرّس والمتعلم خاضعين لإيقاع لا يتحكم فيه أي منهما .
هذا التغير العميق في بنية الإيقاع التربوي لا يمكن اختزاله في عطل تقني أو قصور تنظيمي، بل يتصل بنمط من المخاطر الرمزية التي تحد من قدرة المؤسسة على إنتاج “إجماع زمني” حول العملية التعليمية. فتعدد المنصات، وتباين أزمنة الدخول، وتقطع الاستجابة، كلها مظاهر تؤشر على تآكل الزمن التربوي كمصدر للشرعية .وحين يغيب الانتظام الزمني، يغيب معه الشعور بالانتماء إلى تجربة تعليمية موحدة، وهو ما يُفقد الفعل التربوي معناه الجماعي، ويحوّله إلى تفاعل فردي مبعثر، تضعف فيه سلطة التوجيه والتقويم .
يُلاحظ أن تناول مفهوم “التعليم الرقمي” في هذا السياق يفتقر إلى التحديد المفاهيمي والمنهجي اللازم، إذ لم يتم التمييز بوضوح بين أنماطه وآلياته، ولا بين سياقاته الزمنية والوظيفية، ولا بين حدوده الإجرائية ومضامينه التربوية. وقد أدى هذا الغموض إلى تحويل الخطاب حول الرقمنة إلى فضاء تأملي فضفاض، أقرب إلى الانطباعية منه إلى التأسيس النظري الصارم، مما يُضعف وجاهة الإشكالية ويجعلها مبتورة عن امتدادها الزمني والمكاني.
إن مقاربة التعليم الرقمي بوصفه ظاهرة كونية ومطلقة – دون تحديد ما إذا كنا نتحدث عن مرحلة التعليم عن بعد خلال الجائحة، أو عن نمط التناوب التربوي، أو عن تجربة الإدماج التدريجي للوسائط الرقمية كما هو الحال في مدارس الريادة بالمغرب – تُفضي إلى تعميم غير دقيق، وتُخفي التباين القائم بين النماذج والممارسات. وهذا ما يتنافى مع أبسط مقتضيات البناء المفاهيمي الذي يشترط تحديد الحقول والسياقات.
وتاريخيًا، يمكن استحضار رواد سوسيولوجيا التربية الذين كانوا أكثر صرامة في التعامل مع المفاهيم. فقد حرص بيير بورديو وجان-كلود باسرون، في أعمالهم خلال الستينيات والسبعينيات، على ربط تحليلاتهم للمدرسة الرأسمالية الفرنسية بمنظومة سوسيو-اقتصادية محددة، ورفضوا تعميم خلاصاتهم خارج شروط تشكّله ا¹. لقد اعتبروا أن المفهوم السوسيولوجي لا يمتلك فاعليته إلا إذا اقترن بسياقه التاريخي، وارتبط بوظيفته النقدية، وليس إذا تم توظيفه بشكل معزول عن بنيته المرجعية.
في ظل ما يشهده الزمن التربوي من تفتت ومن انتقال نحو أنماط غير متزامنة، يصبح من المشروع أن نتساءل: هل لا تزال المدرسة قادرة على إعادة بناء مرجعيتها الرمزية في بيئة رقمية لا تُنتج المعنى بقدر ما تُ نتج التشتت والتعدد؟ وهل تملك السلطة التربوية ما يكفي من المقومات لإعادة تأكيد حضورها الوظيفي والرمزي داخل منظومة زمنية لم تعد خاضعة للضبط المركزي، بل باتت تعمل وفق منطق التوزع والتشابك واللايقين ؟
إن هذه التساؤلات لا تندرج ضمن أفق بيداغوجي صرف، بل تلامس أسئلة سوسيولوجية عميقة تتعلق بإعادة تركيب العلاقة بين الزمن، والمعنى، والمؤسسة. فالفعل التربوي لم يعد مجرد سلسلة من الممارسات المضبوطة مؤسسيًا، بل أصبح رهينًا بقدرة الفاعلين التربويين على التفاوض مع واقع زمني مفتوح، لا يمكن التحكم فيه بالكامل، بل يستدعي است راتيجيات جديدة للتكيّف، قائمة على مرونة رمزية، واستبصار تنظيمي، واستعداد دائم لإعادة تأويل المهام التربوية خارج أنماطها التقليدية.
يتبع …