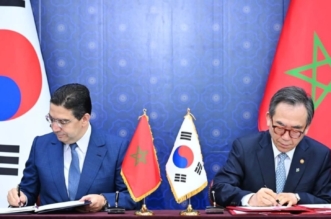محمد أولوة
كما هو معلوم أقدمت وزارة التربية الوطنية على توقيف الدراسة وإبقاء المتعلمات والمتعلمين بمنازلهم حفاظا على سلامتهم وحماية لصحة ذويهم من العدوى وتفادي تفشي انتشار الفيروس. لكن بقدر ما شكل هذا التعليم عن بعد إجراء وقائيا منطقيا لفرض التباعد الاجتماعي وبديلا بيداغوجيا عن الدروس الحضورية المتوقفة وآلية لضمان الاستمرارية البيداغوجية، إلا أنه أضحى تعليما عن قرب بالنسبة للأمهات والآباء والأولياء. تعليما يقض مضاجع الأسر خاصة المعوزة منها التي أصبحت مدعوة وملزمة بالانخراط في هذه العملية التعليمية المستجدة بما أوتيت وما لم تِؤت من إمكانيات لمواكبة تعليم أبنائها وتوفير الظروف المواتية لهم، مما زاد من الأعباء والنفقات الملقاة على كاهلها في ظل ظروف الحجر الصحي المتسمة بالكساد والعسر. وهنا لا يسع المرء إلا أن يشد بحرارة على أيدي الأمهات والأباء والأولياء على سمو وعيهم بخطورة الوضع وتفهمهم للتدابير الاحترازية المتخذة وانخراطهم في إنجاحها لاحتواء تداعيات هذا الطارئ الصحي وتجنيب بلادنا الأسوأ. لكن إغلاق المدارس لمدة طويلة وسد فجوة توقف الدراسة بالاعتماد على تقنيات التواصل الحديثة غير المتاحة للجميع، شكل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لعموم العائلات خاصة وأن السنة الدراسية تشرف على نهايتها. وبالتالي لا يخفى على الجميع الاضطراب الذي عاشته الأسر المغربية والذي تزايدت حدته مع اقتراب مواعد الامتحان، كفترة من الفترات الحرجة التي يعيشها المتعلمات والمتعلمون، بحيث تجتاح موجة عارمة من القلق والتوتر قلوبهم، إذ غالبا ما يقع هؤلاء في هذه الفترة بين سندان ضغط الامتحانات المرتقبة ومطرقة الرغبة في النجاح، وهي الحالة التي تمتد أثارها وانعكاساتها إلى داخل البيوت فيزداد الضغط النفسي والإجتماعي لدى عائلاتهم.
فإذا كان واقع الحال بهذه الصورة في الفترات العادية، فكيف يمكن تصوره في ظل الطوارئ الصحية الحالية وما رافقها من ترقب وانتظار وجهل تام لما تعتزم الوزارة القيام به قبل أن يعلن وزير التربية الوطنية عن عدم استئناف الدراسة الحضورية إلى غاية الموسم الدراسي المقبل، والاقتصار على إجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020. كما سيتم حصر مواضيع امتحان السنتين الأولى والثانية بكالوريا في الدروس المنجزة حضوريا قبل تعليق الدراسة.
وإزاء غياب أية معلومة قبل هذا الإعلان الذي قطع الشك باليقين، عن مآل السنة الدراسية الجارية وآفاق إجراء الامتحانات، وأمام تناسل الإشاعات وتضارب الأخبار غير المعروف الزائف والحقيقي منها، فقد كان من الطبيعي أن تزداد درجة القلق والاضطراب والحيرة ارتفاعا لدى الأسر المغربية بشكل رهيب، لأن الأمر يتعلق بالمصير الدراسي المجهول لفلذات أكبادهم، بل إن منسوب القلق والتوتر أصبح مضاعفا بسبب الظروف التي يمر منها التعليم عن بعد، وما يعتريه من غياب لتكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وبين التعليم العمومي والخصوصي، ومن تباين بين الوضع الاجتماعي للأسر وتفاوت ثقافي بينها على مستوى مواكبة أبنائها لمتابعة دراستهم بانتظام… وهو ما أثار مخاوف كثيرة حول مصير المتعلمات والمتعلمين الذين لم يسايروا دراستهم عبر هذا التعليم المستجد، بسبب عدم توفر مناطقهم على الربط بشبكة الأنترنيت أو لضعف صبيبها، أو لافتقارهم للإمكانيات المادية لعملية التواصل والوسائل التقنية التواصلية من حاسوب ولوحة إلكترونية وهاتف ذكي أوعدم قدرتهم على الاقتناء شبه اليومي لبطاقات التعبئة، أو لعدم إستئناسهم على هذا النمط الجديد من التعليم حتى يتسنى لهم المواظبة على حصص أساتذتهم، أو لعدم تمكنهم من الالتحاق والتسجيل بالمنصات الرقيمة للأقسام الافتراضية خاصة في غياب جهاز إداري خاص بمتابعة نظام تلك الأقسام ومواكبة انخراط المدرسين والمتعلمين في عملية التعليم عن بعد، إلى غير ذلك من الأسباب. ولعلى عدم إدماج الدروس المنجزة خلال فترة التعليم عن بعد ضمن مواضيع الامتحانات، يعد الجواب الأمثل على تلك المخاوف وحلا نسبيا لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق نوع من الإنصاف والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانين المذكورين.
هذا، وإذا كان جواب وزير التربية الوطنية أمام مجلس المستشارين قد أدخل نوع من الارتياح في نفوس العائلات بخصوص مآل الموسم الدراسي الجاري، فإن إجراء الامتحان الوطني والجهوي للباكالوريا لا يزال مرتبط طبعا بتطور مؤشر الحالة الوبائية ببلادنا، وبالتالي فإن الهاجس الصحي الوقائي سيبقى مطروحا لدى الرأي العام الوطني ما لم تكشف الوزارة عن أدق تفاصيل الخطة الإجرائية للتدبير الوقائي والاحترازي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، وكذا مختلف التدابير الصحية الميدانية الصارمة المزمع القيام بها لحماية التلاميذ والتلميذات وكافة الأطر الإدارية والتربوية وتجعلهم في مأمن تام من الإصابة بالفيروس، كأولوية فوق كل اعتبار، حتى تتم جميع العمليات المرتبطة بتنظيم الاستحقاقين المذكورين في أجواء من الطمأنينة والأمان والسلامة.
وبالعودة إلى الأسلوب التعليمي الجديد السالف الذكر والمعتمد لكي لا تتحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر أخرى لانتشار وباء كورونا، فقد تابع المجتمع المغربي بكل شرائحه جهود نساء التعليم ورجاله وهم يرابطون خلف الشاشات والمواقع التعليمية لإنتاج موارد رقمية ودروس مصورة وأخرى مستنسخة وتسخيرهم لإمكانياتهم الذاتية، لإبداع آليات للتواصل عن بعد، وقيامهم بمبادرات قد يكون من شأنها ضمان، ولو هامش معين، من تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين عبر الوطن، لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي، والتقليص من تأثير تداعيات هذه الظرفية الاستثنائية العصيبة على حقهم في استكمال مجزوءاتهم وتأمين زمنهم المدرسي، والتخفيف من منسوب الهدر المدرسي الإضافي الذي قد ينتج عن توقف الدروس الحضورية وعدم مسايرة أفواج من المتمدرسين لدراستهم عبر هذه التقنية المستجدة. وبذلك جسد المدرسون والمدرسات مرة أخرى إيمانهم العميق بقداسة رسالة التعليم وجسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه أجيال هذا الوطن.
وبالتالي فإنه من العبث أن لا يتم استثمار المجهودات المبذولة من طرف جميع الأطقم التربوية والإدارية وتضحياتها الجسيمة، وأن تذهب في مهب الريح دون إخضاعها لتقييم واقعي وموضوعي قصد الوقوف من خلالها على حصيلة التعليم عن بعد وما رافقه من اختلالات وإشكالات ومعيقات للأقسام الافتراضية مع إبراز كذلك مميزات هذا النوع الجديد من الأقسام ومزاياها في إسناد التعليم الحضوري وتحسين مردوديته، إلى غير ذلك من الاستنتاجات التي قد تبرهن على المستوى الحقيقي والفعلي الذي بلغته ما يصطلح عليها بالاستمرارية البيداغوجية. وهو التقييم الذي يكتسي أهمية بالغة لكونه سيعتبر أساسا لتطوير هذا النمط التعليمي الإلكتروني الجديد وتجويده، وإطارا لوضع خارطة طريق تروم إدماجه في المنظومة التربوية كمكمل للتعلم الحضوري ومعزز له وليس بديلا عنه.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما أفرزته كورونا من تداعيات على العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وضمنها قطاع التعليم، والتي تفرض تبني سياسة تعليمية تنبني أسسها انطلاقا من دروس هذه الأزمة الصحية المفاجئة، حيث تأكدت بالملموس، لمن لازال في حاجة إلى تأكيد، ضرورة القطع النهائي مع اختيارات ظل هاجسها لعقود من الزمن هو التخلص من التعليم كخدمة عمومية بمنظور تقنوقراطي مالي ضيق، خضوعا لإملاءات الدوائر المالية الدولية وضغوطاتها القاضية بتقليص الاعتمادات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التعليم. وهي الضرورة الرامية إلى جعل التعليم والبحث العلمي مركز كل السياسات العمومية، وذلك لما يشكله العلم والتعلم من قاطرة للتنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وحتى يرقى إلى مستوى هذا الدور، فإن الأمر يقتضي أيضا الرفع من ميزانيته وتدارك الخصاص المهول في الأطر واللوجستيك والتجهيزات العلمية والعدة البيداغوجية، وبالاستثمار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال والنظم المعلوماتية وفي إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، وتكوين مختصين في هذا المجال وتطوير وسائط التدريس والتعلم للنهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني والرقمي في المنظومة التربوية، وتعميمه وتوفير المستلزمات التقنية للتواصل بالنسبة للمتعلمين المنحدرين من الأوساط الهشة والفقيرة لضمان المساواة وتكافؤ الفرص لجميع التلميذات والتلاميذ بالمدن والأرياف وعلى اختلاف انتمائهم الطبقي، وإعداد الموارد البشرية والكفاءات العلمية والتقنية القادرة على التأقلم مع المستجدات المفاجئة، وتأهيلها لتدبير الطوارئ غير المسبوقة.