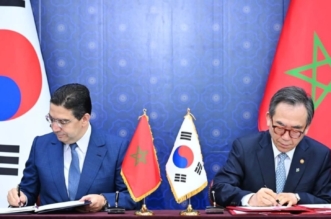يونس الخراشي
موسكو من الطائرة عبارة عن قطع دومينو جميلة على سجاد أخضر. يزيدها النهر بهاء ورونقا. وهي كبيرة بالفعل. حتى إن بناياتها تمتد إلى مسافة غير بعيدة من المطار. كل شيء فيها صارم؛ صارم للغاية. العمارة، والوجوه، والأسفلت، والأمن. بل إن الابتسامات، القليلة، هي الأخرى صارمة. لعلها ما تزال شيوعية.
ومع ذلك، فإن من يذرع موسكو طولا وعرضا لحاجات يقضيها، يكتشف كم هي مؤدبة. فالناس، الذين يكادون يركضون نحو شؤونهم، مثلما يحدث في كل المدن الكبيرة جدا، يبادرون بتلقائية عجيبة لتقديم المساعدة. كل مرة تتوقف، أنت الغريب بسحنتك السمراء، وحملك الثقيل، فتقلب البصر هنا وهناك، تتفاجأ بروسي أو روسية يفرمل نفسه ليسألك:”هل يمكنني أن أقدم مساعدة؟”.
الشباب منهم يستعملون اللغة الإنجليزية مباشرة. الأكبر سنا يفعلون بروسيتهم العجيبة. وكلهم يساعد بطريقته. ثم ينصرف بعد أن يطمئن بأنك وصلت إلى هدفك، وقضيت حاجتك. ثم يتكرر ذلك. بالطريقة نفسها؛ في الشارع أو في ميترو الأنفاق، أو في أي مكان آخر يكون الغريب فيه مميزا عن الآخرين ببطئه، وتوقفه، ويديه اللتين تلوحان في الهواء، أو يشد بإحداهما على رأسه أو صدغه، كي يركز جيدا.

يوم أمس (الخميس)، وهو الرابع عشر من شهر يونيو 2018، كنا مجموعة من الصحافيين المغاربة نذرع شوارع موسكو، ونستعمل ميترو الأنفاق كي نقترب من هدف لا نملك تحديده بيسر. فالخط الروسي متفرد. وهؤلاء القوم يعتزون بلغتهم. قلما تجد ترجمة لكلمات روسية. حتى ماكدونالدز الأمريكية مكتوبة بالروسية حرفا. وتعرف فقط بهويتها البصرية (اللوغو). فاكتشفنا الأدب الروسي عن كثب. أو لنقل أدب الموسكوفيين، وهو الأصح.
بحثنا لفترة طويلة عن مكتب للسفر بالطائرة. كان الهدف سان بتيرسبورغ حيث سيجري المنتخب المغربي مباراته الأولى في كأس العالم. ولأننا غرباء، وزادنا الخط الروسي غربة على غربتنا، فقد كنا نجد أنفسنا نلف حوالي المكان نفسه دون علم. وقررنا في وقت من الأوقات، ورغم المساعدات التي تلقيناها، أن نلتجئ إلى سائق طاكسي، لعله يدلنا. فقد جرى العرف بأن سائقي الطاكسيات هم أعرف الناس بتفاصيل المدن.
هاتفنا أحدهم. انتظرنا دقائق فإذا به أمامنا. اكتشفنا أنه لا يعرف غير الروسية لغة. وسرعان ما بدأنا نستعمل تقنية الترجمة الفورية بالصوت كي نتفاهم. ثم إذا بشابة أنيقة، تحمل كتابا على غلافه صورة للفنان الهولندي فان كوخ، تتوقف. قالت:”هل لي أن أساعدكم؟”. قدرنا أن الأمر سيتطلب دقائق فقط. رحبنا. ابتسمت. راحت تحصل منا على معطيات، ثم تنقل إلى سائق الطاكسي. لعل التواصل يكون أفضل.
فجأة توقفت سيدة أكبر سنا. سألتني بلهجة فيها صرامة إن كنت أتحدث الإيطالية. قلت لا. ثم إذا بها ترفع صوتها، وتخاطب سائق الطاكسي. تخيلت، ومعي زملائي، أنها ترغب في استخدام سيارة الأجرة بدلا منا. فطريقتها في الكلام شابهت الخصام. حتى وهي تتحدث مع الشابة الأنيقة، بظفيرتها، وتنورتها الطويلة. ولم نفهم إلا في ما بعد أن تلك السيدة كانت تريدنا أن نحجم عن استعمال الطاكسي. فيبدو أنها التقطت ما نريده، وإذ رأت أنه ليس بعيدا، فلم يكن من داع لنخسر بعض الروبلات التي قد نحتاجها لغرض أهم.
في لحظة ما صرنا نتفرج فقط. صار الحديث ثلاثيا بين السائق والشابة والسيدة. بل إن سائق الطاكسي خرج من سيارته، ليكون الكلام أكثر وضوحا، وهو يستعمل الإشارات أيضا. ساد صمت قصير، ثم إذا بالشابة تقول لنا:”المكتب الذي تبحثون عنه قريب جدا. لن تحتاجوا إلى طاكسي. أنا سأقودكم إليه. لا تقلقوا”. حينها تبسمت السيدة. راقها تصرف الشابة. أما سائق الطاكسي، الذي ربما يكون جاءنا من مكان بعيد، فلم يبد أي تذمر. قبل بالصفقة. وعاد إلى مكانه وراء المقود.
سرنا لبعض الوقت مع الشابة. كانت تسرع الخطا، حتى ظننا أنها تأخرت عن موعد مهم. اعتذرنا. وإذا بها تسألنا عن هويتنا. أما وقد أخبرناها بأننا مغاربة فقد انشرحت. علت وجهها ابتسامة تدل على ذلك. قالت إنها تعرف المغرب. أكادير، الصويرة، البيضاء. قالت إنها زارت مهرجان الصويرة للفن الكناوي. وقالت إنها أعجبت بمدينة الدار البيضاء كثيرا. ومضت بنا، مثل معلمة تقود أطفالا إلى الحديقة.
حين وصلنا إلى باب فندق قريب، قلنا لها :”كنا هنا من قبل”. ابتسمت دلالة أن اتبعوني، إنكم غرباء، ولن تعرفوا السبيل أفضل مني. واتضح أنها كانت محقة. هاتفت مستخدمي المكتب. وبعد حين وصلت شابة تعمل هناك. تكلما معا لبعض الوقت بالروسية. شرحت لها بإلحاح. كنا نستغرب لهذا السلوك الرائع. فالناس مشغولون في المدينة الكبيرة. كيف لشخص ذاهب إلى حاجة يقضيها يهتم لأمر غريب بكل هذا الحرص؟ كيف؟ هذا ما حدث. بل هذا ما حدث لمرات.
ابتسمت الشابة مرة أخيرة. شكرناها كثيرا. ثم انصرفت، بعد أن اطمأنت بأننا بلغنا هدفنا. ثم سرنا مع الشابة العاملة بمكتب السفر بالطائرة. اكتشفنا ساعتها بأننا أخطأنا الطريق لدى ولوجنا للفندق في المرة الأولى. كان خطأ بسيطا، ولكنه يقودك إلى وجهة مغايرة. ولاحظنا بأن المكتب صغير للغاية. يوجد في آخر بهو طويل بالطابق الثاني. باب بسيط يقود إلى غرفة. هناك ثلاثة مكاتب فقط.
هناك ستبدأ حكايتنا الثانية ذلك اليوم. كانت غريبة للغاية. لكنها تثبت بأن الأدب الروسي عظيم جدا. فالروس ناس مؤدبون. ولديهم آداب، وأخلاق، مثلما لديهم أدباء، وروايات ومسرحيات وأشعار لا تضاهى.
يتبع
عن أخبار اليوم