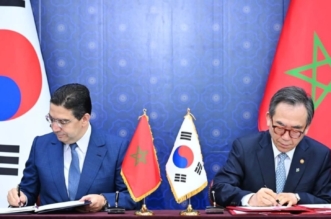حسن ادوعزيز
إن ما يمكن أن يستنتجه كل باحث متمعن ودارس متتبع لتاريخ المجتمع الأمازيغي بالشمال الإفريقي والغرب الإسلامي عموما، هو ان هذا المجتمع مجتمع تسامح وتثاقف بامتياز؛ بحكم الموقع الجغرافي لهذه المنطقة، كمكان مرور تاريخي للعديد من الشعوب الإفريقية، والأوربية، والمتوسطية..منذ العصر القديم الى الآن. مما يؤكد بان شعوبها لم تكن سلبية ومنعزلة، كما تُشير الى ذلك بعض الدراسات؛ بل ساهمت الى حد كبير في بناء حضارة حوض البحر الأبيض المتوسط. ذلك أن “الأمازيغ لم ينتظروا مجيء الشعوب الأخرى، او وصول “ماسينيسا” الى السلطة ليُدخلوا سهولهم الخصبة الى الحضارة” (على حد تعبير كابرييل كامبس Gabriel Gamps).
لقد كان هناك نوع من التثاقف الإيجابي بين المجتمع الأمازيغي والشعوب القديمة التي احتكت به. ولعل “الحضارة الفنيقية” بقرطاج لازالت تحتفظ ببقايا امازيغية في لغتها وديانتها، كما يتجلى ذلك في اسم آلهة قرطاج القديمة “تانيت” التي تحيل على أصول أمازيغية واضحة، كما يشير الأستاذ الأكاديمي المغربي “محمد شفيق”. وقد امتد هذا التثاقف الى الثقافة الهيلينية بدورها؛ على اعتبار أن تأثير هذه الثقافة السحري على حوض المتوسط، منذ القرن 5 ق.م، لن يترك الأمازيغ دون مبالاة. إذ تشير بعض الدراسات أن الملوك والمثقفين ورجال الدين الأمازيغ كــ “ماسينيسا” و”جوبا الثاني” و”أبولي” (apulée) والقديس “أوغستين” (Saint Augustin) كلهم كانوا متأثرين وشغوفين بهذه الثقافة. كما أن جل النقائش الأثرية “الليبية” و”الفنيقية” تُعطي هي الأخرى صورة واضحة عن بعض القوانين العرفية، التي كانت جزءا أساسيا في القوانين المتبعة من طرف الحكومات البلدية، خلال فترة حكم الممالك الأمازيغية (حوالي 138 ق.م)؛ وهو ما يؤكد صمود التقاليد والقوانين العرفية والثقافة المحلية ومقاومتها، ولمدة طويلة، التغييرات التي جاءت بها سياسة الرومنة.
إن هذا التثتاقف استمر مع مجيء الاسلام إلى المنطقة خلال العصر الوسيط. فقد بقي الأمازيغ أوفياء لثقافتهم وأعرافهم في الوقت الذي لم يرفضوا فيه الثقافة الشرقية الوافدة. ذلك أنهم كانوا قد اكتسبوا دعائم الدين الجديد دون الانسلاخ عن أعرافهم وقوانينهم، وحتى بعد قيام تنظيمات وامبراطوريات شاسعة امتد صيتها الى مجموع العالم الإسلامي أنذاك. فنفس ما وقع مع الثقافة الفنيقية والرومانية كان قد وقع مع الثقافة الإسلامية، مع “ابن تومرت الموحدي” في ميدان الحكم، ومع “ابن رشد” (1126-1198 م) في ميدان الفلسفة، و”ابن خلدون” (ق 14م) في ميدان التاريخ. فالحياة السياسية والفكرية التي يقدمها هؤلاء تتميز بنوع من الخصوصية والأصالة في الآن ذاته؛ مما يفسر لنا التميز الواضح الذي نلمسه، والى حدود الآن، بين الفكر المغاربي والشرقي. فالمؤكد أن الثقافة الأمازيغية والذهنية المغربية عموما تبدو أكثر قربا إلى الفكر العقلاني؛ ويكفي برهانا على هذه الفكرة أن أغلب الديانات الكبرى التي اعتنقها الأمازيغ كسكان أصليين للمنطقة، كانت كلها نتاج ثقافات دخيلة عليهم، وليست وليدة ثقافة ومسلمات أصلية محلية. وإذا عدنا إلى تاريخ شمال افريقيا والأندلس خلال أوج الثقافة الإسلامية في العصر الوسيط؛ سنجد أن الفكر الإسلامي الذي تطور في ظل الإمبراطوريات الأمازيغية الكبرى، خصوصا بــ”مراكش” و”قرطبة”، يتميز بعمق شديد عن الفكر الإسلامي الشرقي خلال نفس الفترة التاريخية. وربما يظهر هذا التميز بوضوح شديد وكصراع ذهنيات، بين “ابن رشد” الذي يمثل الفكر المغربي، و”الغزالي (توفي سنة 1111م) الذي يمثل الفكر الشرقي. فمؤلفات “ابن رشد” عملت على تهديم النظرية الشرقية التي تُهمش العقل، وتواجه فلسفة المسلمات التي تُسوقها مؤلفات الغزالي حول خلق الكون ونهايته، وانبعاث الأجساد…
ولعله نفس المنحى سيتبلور عند العلامة “ابن خلدون”بعد حوالي قرن من الزمن على وفاة ابن رشد. فهذا المؤرخ الكبير استطاع بشكل ملفت إدخال التحليل الفكري العقلاني في الخطاب التاريخي. والمقارنة الواقعية التي اختارها سمحت بشكل كبير للباحثين من بعده بفهم ميكانيزمات النتائج التاريخية. وربما ذلك ما جعله يشكل حتى الآن رمزا واضحا للدقة، وللنفعية، وللعقلانية، في غياب تام للمسلمات، من خلال أعماله التي تعتبر أجود ما استطاعت الحضارة الإسلامية إنتاجه. فهو رمز تاريخي كاف على أصالة مجتمع متسامح، لم يرفض كليا ثقافة الشعوب الأخرى، بل في المقابل عمل على دمجها في هويته بشكل حافظ على أصالته العميقة.