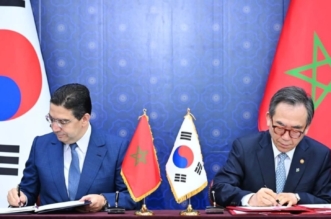أيمن نبيل
اختزلَت أفلامُ البورنو في القرن العشرين توتّراتٍ قيميّةً واجتماعيّةً في العالم الصناعيّ، فاندرجتْ في تطوّر مفاهيم الحرّيّة والمحافظة وإيديولوجيا الأنوثة والذكورة والقيم
الرأسماليّة وغيرِها. أمّا في المجتمعات العربيّة المستهلِكة، فلا ينطوي البورنو على تحوّلاتٍ قيميّة. صحيح أنّ الأدب الإيروتيكيّ العربيّ الحديث أشعل نقاشاتٍ مهمّةً، وارتبط عضويًّا بقضيّة الحرّيّات، إلّا أنّ البورنو ـــ بمباشرته المروِّعة ـــ بقي بلا أنصار فعليين في الساحة الثقافيّة العربيّة. وربّما كان البورنو من القضايا النادرة التي تتّفق آراءُ اليمين واليسار إزاءها، مع انتشاره الساحق رغم كلّ محاولات المنع، كاشفًا فشل القوى التقدميّة في إيجاد مقاربة واقعيّة للمسألة المركزيّة: المسألة الجنسيّة.
الريف والمدينة
المجتمعات العربيّة عمومًا ليست مجتمعات مدينيّة؛ ذلك أنّ أنماطَ الإنتاج وتركُّزَ السكّان وتشوّهاتِ المدينة تجعل الثقافة الشعبيّة الريفيّة مركزَ إنتاج القيم الاجتماعيّة. ولهذا، يصبح أيُّ اختراقٍ ثقافيٍّ للريف حدثًا كبيرًا ينبغي تناولُه بحذر. ومن هذه الاختراقات وصولُ البورنو إلى الأرياف مع الوصول المتأخّر للكهرباء والهواتف المحمولة؛ ما يعني أنّه كان يشقّ طريقَه بثقةٍ في عمق مركز الثقل السكّانيّ ومُنتِج القيم الاجتماعيّة لبلداننا الفقيرة.
إبّان انتشار أجهزة الفيديو في المدن، كانت مشاهدةُ البورنو صعبةً قليلًا لأنّها تحتاج إلى عناصر تكنولوجيّة مختلفة. ولكنْ مع ظهور الهاتف المحمول المشغِّل للفيديوهات، أصبح الأمرُ شديدَ السهولة. وشكّل انعدامُ التوازي بين التقدّم الاقتصاديّ وانتشارِ الأفلام الإباحيّة أحدَ التمظهرات الثانويّة لعجز القوى التقدّميّة عن ربط الحرّيّة الجنسيّة بالشروط الاقتصاديّة للمجتمع. وظلّ أغلبُ المثقّفين التقدّميين العرب حبيسَ خطابٍ يتذمّر من الثقافة الاجتماعيّة المحليّة، أو يتبنّى نزعةً محافظةً في الجنس، عوضَ البحث في الشروط التي تقتضيها الحرّيّة الجنسيّة في مجتمعاته. ونتيجةً لغياب التنمية الاقتصاديّة وسيطرةِ الثقافة الريفيّة على المجتمع العربيّ، تتضاعف مشاكلُ مشاهدة البورنو، فتبقى معرفةُ الذكر/الأنثى لجسد الآخر محصورةً في الأفلام الإباحيّة. ثمّ إنّ الكبت المستمرّ والمشحوذ بالبورنوغرافيا يُنتج أوهامًا تنهار عند أوّل لقاءٍ جنسيّ (متأخّرٍ عادةً)، وتنتج من هذا الانهيار إشكالاتٌ اجتماعيّة/جنسيّة عديدة ومستعصية.
تسييس البورنو
مع ظهور الأفلام الإباحيّة، أصبح البورنو شريكًا لنقد الدين، الموضوعِ السجاليِّ الأبرز منذ الربع الأوّل من القرن العشرين، في عمليّات التسييس الممارسَةِ من قِبل الدولة والأحزاب معًا. ولأنّ نقدَ الدين، والإلحادَ، كانا يلقيان مناصرِين اتّكاءً على قيمٍ مثل حرّيّة التعبير، فإنّ الميلَ المحافظَ لدى النُظُم القمعيّة ـــ وهو ميلٌ استعر منذ السبعينيّات نتيجةً لتحالفاتها مع الإسلاميين لضرب اليسار ـــ كان يواجَهُ بشراسةٍ من قِبل المثقّفين. أمّا ساحة البورنو فخلت تقريبًا من المناصرين؛ ولهذا كانت الساحةَ المفضّلةَ لعقد الصفقات المريحة بين الدولة القمعيّة والتيّارات الإسلاميّة، ولكسب تأييد القطاعات الاجتماعيّة المحافظة.
في اليمن، في العقد الأوّل من هذا القرن، وقبل انتشار الهواتف المحمولة المشغِّلة للفيديو، كانت مقاهي الإنترنت في المدن مكانًا مناسبًا لمشاهدة البورنو، خصوصًا أنّها احترمت الحيّزَ الخاصَّ للزائر، وذلك عبر وضع فواصلَ بلاستيكيّة أو خشبيّة بين أجهزة الحاسوب وتوجيهِ شاشاتها إلى الجدران. هكذا ضمِن الزائرُ مشاهدةً هادئةَ البال، وحلًّا لا بأس به لأزمة مشاهدة البورنو، وإنْ كان في الأغلب حلًّا للذكور لا للإناث، وذلك لخوفهنّ من انكشاف أمرهنّ، ومن فضحِ صاحب المقهى لهنّ أو ابتزازهنّ. ولكنْ ما إنْ بدأ مجتمعُ المدينة يعتاد البورنو في المقاهي حتى أصدرت السلطاتُ أوامرَ بنزع الحواجز بين الأجهزة في المقاهي، وبتوجيهِ الشاشات إلى الخارج. هذا بالإضافة إلى حجبها للمواقع الإباحيّة وتفتيشها مقاهي الإنترنت لمحاربة البورنو (بأمر من وزارة الثقافة على ما أخبرني أحدُ أصحاب المقاهي!). وكان هذا نوعًا من مزايدة السلطة على الإسلاميين في فترة الاختلاف السياسيّ، وتمظهرًا لنزوعها المحافظ/التأديبيّ تجاه المجتمع.
غير أنّ تشابك البورنو مع التكنولوجيا سحق كلَّ وسائل المنع. وكان آخر انتصار للبورنو هو الهواتف المحمولة التي تتطوّر باستمرار. فتأكّدتْ بذلك نبوءةُ الكاتب والبورنوغرافيّ الأميركيّ وليام روستلر: “الأفلام الإيروتيكيّة وُجدتْ لتبقى.”
بدخول صناعة البورنو عالمَ الإنترنت تضاعف إنتاجُها وتحسّن، وأصبحت تجتذب آلافَ الشابّات والشباب. ولو حدث أن انهارت هذه الصناعةُ يومًا، فإنّ مكتبة الأفلام الإباحيّة التي أنتجتها، وهي موجودة الآن على شبكة الإنترنت، يمكن استجرارُها على الدوام. الطريف في الأمر أنّ التطوّر التكنولوجيّ لا يضمن خلاصَ البورنو من المنع وحسب، بل يفكّ ارتباطَ صناعة البورنو بالربح أيضًا. فمع ظهور الإنترنت حصل شرخ كبير بين إنتاج البورنو واستهلاكه. ولعلّ من المفارقات أنّ المواطن العربيّ يشهد راهنًا شيئًا من ملامح المجتمع الشيوعيّ المثاليّ في أمرين: الكتب الإلكترونيّة والأفلام الإباحيّة!
أزمات ثقافيّة
لا تزال البورنوغرافيا موضوع نقاشٍ ثقافيّ في كلّ المجتمعات. في ألمانيا التي كانت في العام 2007 السوقَ الثانيةَ للبورنو بعد الولايات المتّحدة، فرض معيدٌ في قسم الأدب الإنجليزيّ، في جامعة دارمشتات في الفصل الدراسيّ الماضي، على طلّابه كتابةَ نصوصٍ بورنوغرافيّة وقراءتَها أمام زملائهم. وقد أثارت هذه التجربةُ نقاشات مهمّةً، منها ما أدلى به المعيدُ في حديثه إلى دير شبيغل، حين قال: “نحن لسنا منفتحين كما يُخيّل إلينا!”
عند نقاش الأزمة الثقافيّة عربيًّا، نجد أنّنا أمام إشكالاتٍ مختلفة. أوّلُها أنّ إنتاجَ البورنو عربيًّا شبهُ معدوم؛ وإنْ وُجدت إفلامٌ إباحيّةٌ عربيّة، فهي لا تخرج عن كونها “فضيحةً” أو تصويرًا يركّز على إخفاء هويّة المنخرطين فيه. وفي الحالين تكون الرداءةُ هي “الميزةَ” الوحيدةَ للبورنو العربيّ. ومن ثمّ فإنّ الإغراء الجنسيّ، في مخيال الجيل العربيّ الذي عرف البورنو، يتركّز على الجنسيّات التي شاهدها تمارس الجنسَ، وذلك بإشراف صناعةٍ رأسماليّةٍ كاملةٍ وذاتِ إرثٍ كبيرٍ من الخبرات.
الأزمة الثانية كانت النزعة المحافظة في المجتمع العربيّ، وهي تشبه أزمة المحافظة في الثقافة الأوروبيّة والأميركيّة. فقد تعاونتْ قوًى سياسيّة، وجهازُ الدولة، وكثيرٌ من الصحفيين والكتّاب، لمنع البورنو، ولكنّهم فشلوا جميعًا. أحدُ جذور أزمة المحافظين عربيًّا هو أنّ جهازَ الدولة، الذي كان يميل إلى المحافظة في البداية بحكم ظروف الحرب الباردة ومحاربة الشيوعيّة، أصبح بعد ثلاثين عامًا ذا تكوين وبنية محافظيْن فعلًا. وبالتالي لم يحتج المحافظون إلى الدخول في معارك رأي عامّ لتوضيح وجهات نظرهم، بل استقووا بجهاز الدولة لـ”المنع” مباشرةً. وعليه، فإنّ انتصار البورنو الساحق هو في الواقع ضربةٌ كبيرةٌ للبناء العربيّ المحافظ القمعيّ. لكنّ المحافظة الغربية، بعد إخفاقاتها المتكرّرة أمام النزعات المتحرّرة، اضطرّت إلى دمقرطة نزوعها المحافظ لكي تضمن البقاء. وهكذا تمّ تحويلُ المحافظة من قمع إلى موقف.(1)
الأزمة الثالثة هي ندرة وجود مثقّفين عرب محافظين وديمقراطيّين في الوقت الراهن، وذلك لأسباب عديدة، منها أنّ المحافظة العربيّة لا تتحرّك في مجتمعٍ يسير نحو التحديث. ومنها أنّ فكرة الديمقراطيّة لم تدخلْ في وعي النخبة بالقدر الذي يسمح للمثقّف بتخيّل موقفٍ محافظٍ قابلٍ للتأصيل والإسناد، وغيرِ مترافق مع المنع والتنكيل بالآخرين.
الأزمة الرابعة هي أنّ البورنو وضع النخبةَ العربيّةَ في مأزق تبرير الرفض. فالمحافظون عادةً يبرّرون الرفضَ دينيًّا ـــ وهذا لم يعد كافيًا لفرض المنع. وهنا يتحدث مثقّفون تحرّريون عن فكرة صحيحة، وهي أنّ البورنو تسليعٌ للنساء. لكنّ مشكلة هذا الطرح أنّه يناقض مجموعَ مواقفِ قائله: فالديمقراطيّ الجذريّ يجب أن يرفض تسليعَ البشر جميعًا، لا تسليع نجماتِ البورنو وحدهنّ؛ وعليه أن يتذكر أنّ البورنو يسلّع الرجالَ أيضًا؛ وعليه أن يناهضَ الدولة القمعيّة التي لا تسلّع البشر فحسب بل تستعبدهم وتنتهك آدميّتهم أيضًا. ثمّ إنّ حجّة تسليع البورنو للبشر غير كافية، بالنسبة إلى أيّ ديمقراطيّ حقيقيّ، من أجل منع الناس من مشاهدته؛ فهو ليس على الدوام تسليعًا قهريًّا واستغلالًا للفقر كالدعارة، أو استغلالَ الاقتصاد الانتاجيّ للبشر واحتياجاتهم كما يحدث في الصين والهند أو كما تفعل شركاتُ الشوكولاتة الغربيّة في أفريقيا.
***
تميّز البورنو منذ بداياته بملمحين رئيسين: الأوّل هو ذكوريّته الكاملة؛ فالأنثى هي الموضوع، والمخاطَبُ هو الذكر. الثاني هو “لاواقعيّة” الجسد المصوّر في البورنو؛ وهو أمرٌ استفحل وتفاقم مع تطوّر تقنيّات الطبابة التجميليّة.
في التسعينيّات، ظهر البورنو النسويّ، وهو يحاول تجاوزَ عيوبِ البورنو المكرَّس. ولا يعني هذا أنّه نجح في محاولته هذه، ولكنْ عربيًّا لا يعرف كثيرون عن هذا الموضوع. ولأنّ الجنس تابو اجتماعيّ، فإنّ كثيرين لا يستطيعون الوصول إلى معلوماتٍ بخصوص تطوّرات البورنو صناعةً وتوجّهات.
من جانب آخر، يتسبّب قياسُ بعض المثقّفين لسياق ممثّلات البورنو على السياق الاجتماعيّ للدعارة في العالم العربيّ في عدم فهم تطوّر البنية الداخليّة لظاهرة البورنو في الثلاثين عامًا الماضية. نستطيع رصد تطوّر العاملات هذه الصناعة بالمعنى الطبقيّ من خلال استعراض بعض الأمثلة. فالممثّلة الإباحيّة أودري بيتوني تحمل شهادة بكالوريوس في الصحافة؛ ومِيا خليفة في التاريخ؛ وساشا جراي من عائلة كاثوليكيّة محافظة، وهي مثقّفة تقرأ لنيتشه، ومهتمّة بالموسيقى، كما أنجزتْ روايةً تلقّفها بعضُ النقاد باهتمام؛ وأليتا أوشن درستْ في مدرسة بودابست لإدارة الأعمال. وكلّهن، مع كثيراتٍ غيرهنّ، يشكّلن نموذجًا مختلفًا تمامًا عن النموذج السابق في الربع الثالث من القرن الماضي، اي النموذج التقليديّ للخلفيّة الطبقيّة للمشتغلات بالدعارة (أمثال نجمة الثمانينيّات الشهيرة ترايسي لوردز).
إنّ عدم دراسة هذا السياق الاجتماعيّ لنجمات البورنو يجعل المثقّف عاجزًا عن إدراك الجوهر الرأسماليّ المروِّع لصناعة البورنو. فلم يعد الانخراطُ في أفلام البورنو وسيلةً للكثيرات من أجل “التخلّص من الفقر والوفاء بالمسؤوليّات،” كما يروِّج النموذجُ المكرّس لتعليل الدعارة في الروايات والسينما العربيّة، بل بات وسيلةً للترقّي الطبقيّ لفتيات من الطبقة الوسطى حاصلاتٍ على شهادات جامعيّة، أو للترقّي الاجتماعيّ: فقد تمكّنتْ بعضُ نجمات البورنو، بعد اعتزالهنّ، من دخول عوالم السينما والكتابة الإيروتيكيّة، والانخراطِ في المجتمع المدنيّ، وتقديمِ الرأي في شؤون السياسة بصفتهنّ “نجمات” اجتماعيّات.
ويُلاحَظ هنا أنّ مسألة الاندماج الاجتماعيّ لنجمات البورنو ما زالت في طور محاولة الإقناع، ويُبالغ في أبعادها وتسويقها عادةً لأغراض ربحيّة ونفسيّة؛ فأهمّ مقياس للقبول الاجتماعيّ هو مؤسّسة الزواج. ومن الملاحظ أنّ زيجات نجمات الأفلام الإباحيّة ما تزال محصورة في رجال ينتمون مهنيًّا إلى صناعة البورنو، إخراجًا أم تمثيلًا.
***
موضوع البورنو عامةً، وفي السياق العربيّ خصوصًا، يحتاج إلى أبحاثٍ كاملة. ونعتقد أنّ أيّ نقاش عقلانيّ حول النسق الأخلاقيّ والمسألة الجنسيّة في العالم العربيّ لا بدّ من أن يمرّ على البورنو محطّةً رئيسةً، لا لاشتباكه الطبيعيّ بإشكاليّة الجنس فحسب، بل لأنّه مشتبكٌ أيضًا بمصائب الثقافة لدى كثير من المثقّفين.