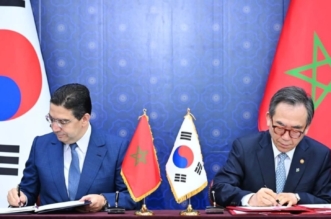عبد اللطيف الوراري
يكاد مصطلح الحساسية، في نقد الشعر المغربي، يكون غائباً في ظلّ الحظوة التي كانت لمصطلح الجيل. ولم يتردّد بقوّة إلّا في بدايات الألفية الجديدة، في بعض المقالات والبيانات التي كان يحرّرها الشعراء الجدد أنفسهم، وفي كتاباتهم التي كانت تتمّ في صمت، وتحاول ابتكار أشكال تعبير خاصّة بها، وإيجاد موطئ قدم في خارطة المشهد الأدبي. لكن بُنى الاستقبال الثقافي والإعلامي والجمالي التي يفترض أن تحتضن إبداعهم وتساهم في انتشاره، كانت عاطلة وصمّاء.
كان الشاعر الراحل منير بولعيش من الأوائل الذين لفتوا النظر إلى الشعراء المغاربة الجدد ونعتهم بـ “جيل المشيتين”، وقال إنّهم “تمثيل حقيقي لانعطافة متميّزة ونقلة جديدة” للشعر العربي، ما فتئ يرسّخ “طريقه للبحث عن صوته الخاص، وركضه الحثيث من أجل موقع ثابت له وأسلوب متفرّد يوقّع به نشيده الخارج على رداءة السياق العام”. بيد أنّ الشاعرمصطفى ملح وجّه نقداً لاذعاً إلى التجربة التي عدّها “شعراً جامداً لا إحساس فيه”، وقال “إنّنا نعيش عصر انحطاط شعري في المعنيَين؛ التاريخي والفنّي”، مبرّراً بأنه “يمكن تصفّح المجاميع الشعرية التي ينشرها البعض باستمرار، وبلا خجل، كما ينشرون سراويلهم في الريح!
لكن، ما إن أكملت العشرية الأولى من الألفية الجديدة دورتها، حتّى بدا لأكثر الدارسين ونقّاد الشعر أنّ هناك حساسيّةً جديدة تخترق القصيدة المغربية المعاصرة.
وما كانت التجربة الجديدة في الشعر لتجبّ ما سبقها، إذ هي تراكم لتجارب متتالية في سياق القصيدة المغربية الحديثة بقدر ما هي تجاوزٌ لها. تظهر حبلى بالانعطافات التي تحفّز شعراءها على التحرّك الدائم، فلا يرهنون ذواتهم لإيديولوجيا أو ينضوون تحت يافطة بارزة من قبيل “الجيل”، و”الائتلاف”، و”الجماعة”. إنّها تعني صعود حساسيّة جديدة. إذ تكشف عن كونها كنايةً عن اختلاف في تشكُّلات الرؤية الإبداعية، أو في تصوُّرها لأفق الكتابة الشعرية، في سياق ما خلقته اقتراحات الشعراء الجدد، وما صارت إليه رؤاهم المختلفة إلى الذوات والأشياء، فقد مال كثير منهم إلى الرؤيا التي تُعنى باكتشاف العالم ومواجهته، عوضاً عن الموقف المباشر من السياسة والأخلاق والقيم.
الحساسيّة هي أصل الشعر، والشعر دائماً ما كان ينشأ من خلال حساسيةٍ ما؛ في اللغة، أو في المتخيّل، أو في الرؤية، أو الأسلوب وطريقة التأليف الشعري. تاريخ الشعر هو تاريخ حساسيّات متراكمة ومتجاذبة، إذ تحلّ محل الحساسية القديمة حساسية جديدة.
وأبان عدد غير يسير من شعراء التجربة الموهوبين، من خلال اجتهاداتهم واقتراحاتهم، عن وعيهم باشتراطات الحساسية الجديدة، فانحازوا إلى شعريّتها التي تقوم على تنوّع الرؤى وتمايزها، وتكشف عن تحوُّلٍ في الحسّ الجمالي، وفي مفهوم الذات والنظر إلى العالم، وفي تقنيات التعبير الفني للقصيدة.
لكن هذه التجربة التي لم يتجاوز عمرها العقدين، لا تزال ملامح حساسيّتها الفنية غير مكتملة؛ فهي تتدفّق باستمرار، وهي ليست حكرًا على الشعراء الجدد بل يساهم فيها أيضاً شعراء من أجيال سابقة: محمّد السرغيني، محمّد بنطلحة، محمّد بنّيس، مبارك وسّاط، وفاء العمراني، حسن نجمي، تمثيلاً لا حصراً. فإنتاج هؤلاء، يُمثّل حافزاً إضافيّاً للشعراء الجدد من أجل الاستمرار في رهانهم الجمالي على تحديث الشعر المغربي، بلا ادّعاء القطيعة أو وهم “قتل الأب”.
تفاصيل اليومي والذات
لو طالعنا نصوص التجربة الشعرية ابتداءً من مطالع التسعينيّات وعبر بدايات الألفية الجديدة، لوجدنا أن الشعراء لا يكتبون بسويّةٍ واحدة، ولا يجمع بينهم فهْمٌ محدّدٌ للعمل الشعري، لكن ثمة سمات معينة، لعلّ أبرزها عزوفهم عن المعضلات الكبرى والهواجس التاريخية والسياسية، والانهمام بالذات في صوتها الخافت، وهي تواجه بهشاشتها وتصدُّعها العالم والمجهول. هناك الذات فقط. الذات المتصدِّعة التي تشي بعزلتها وبالولاء لحزنها الدقيق، وقد ولّت ظهرها لتلك المعضلات التي بدت بلا جدوى، وعكفت عوضاً عن ذلك، على ما يعجّ به اليومي والعابر والهامشيّ والخاصّ من تباريح وتناقضات وتفاصيل وإيحاءات، مرتفعةً بانفعالاتها واستيهاماتها وعلاقاتها وحيواتها إلى مستوى أسطرتها، وبالتالي شخصنة متخيّلها الشعري.
ثمة من ارتفع بسؤال الذات وانفعالاتها إلى مستوى أسْطَـرتها، ومن أهمّهم بوجمعة العوفي، إسماعيل أزيات، عبد السلام دخان ومحسن أخريف. يكتب عبد السلم دخان: “بمحاذاة أزقّة مفتوحة العينين/ وأرصفة لا تشبه خطى الأطفال/ على إسفلت لا يذكر صهيل الخيل/ تمضي الأجساد نحو غيّها بلا ندم/ لأنها مجبولة على الألم/ العقارب في الساعات تلدغ أصحابها/ الواحد تلو الآخر في الممر الطويل/ نحو مخالب الواحة”.
ومنهم من يلهج بالحبّ والأمل في إعادة صياغة الحياة والتحرُّر من القيود، أو التّوْق لتحقيق التوحُّد مع المطلق، إذ تتنقّل الأنا الشعرية عبر تحوُّلاتها الحسّية أو الميتافيزيقية في الزمان والمكان، وعبر غنائيّة تطفح بالحبّ والحكمة والحلم، تعيد إنتاج مدلولاتها، كما لدى رجاء الطالبي، صباح الدبي، نجاة الزباير، رشيد خديري. تكتب صباح الدبي: “يا مطراً في سمواتِ عينيه/ هل ضاقتِ الأرضُ/ حتى تظلَّ معلَّقَةً قطراتُكَ لا تشتهِي أرضَهَا/ كم من الغيمِ يكفيكَ حتى تفُورَ/ عيونُ السَّمَاءِ التي رفعتكَ/ وحتَّى يمورَ الأديمُ الذي أنزَلَكْ/ هل تدثَّرتَ بالبحرِ حتَّى تعانقَ فيكَ النوارسُ صبحاً/ وتشربَ أنخابهَا/ هل تسلَّلْتَ منْ جسدِي الزِّئْبَقِي/ حين أورثكَ الطِّينُ بعضَ تقاسيمهِ وانتَثَرْ”.
وثمّة من يلوذ بذاكرة الطفولة والمكان الآبد في مواجهة الزمن المتفلّت وعذابات الحاضر، ما يطبع الأنا الشعرية بدلالات تجد متنفّسها الرمزي في فضاء الموت والصمت والغياب، كما لدى جمال أزراغيد، أحمد الدمناتي وحليمة الإسماعيلي. ففي شعرهم تتكشّف استقالة الذات من الواقع، ونفض اليد عن إلزاماته الضاغطة، كما لدى سعيد الباز، إدريس علوش، حسن ملهبي ومصطفى الرادقي. يكتب ملهبي: “أردت أن أرتّب دولاب غرائزي وأن أمنح للقسوة مبررًا أخلاقيًا، حتى ينبت عشبٌ من فكرة ذهابك. أستقبل الألم في أرض محايدة، في ذلك نوع من الخداع.. حتى لا يكون الألم سلطة أو تدميرًا ذاتيًا، وتكوني أنت فقط دون فائض في المشاعر”.
هناك من نذر شعره لفضح الحضارة المادية المعاصرة، إذ لا يكفّ عن نقدها والسخرية منها، من داخل مفردات هذه الحضارة نفسها، ولا سيّما التقنيّة التي أغرقت الجوهريّ والإنساني في عصر الأتمتة، كما لدى أبو بكر متاقي، طه عدنان، يونس الحيول، نور الدين بازين ونجيب مبارك. يقول متاقي: “أنا على الأقلّ أصارح السواري بحقيقتها :/ “حَمَّالَةُ الملل بدلاً عن الآخرين”/ هل حملت أنت أثقال غيرك؟/ اسمعي ما يقوله الطبل:/ “الجهات تكرهني/ كل خبطة مدية في جسد الصمت/ وكالرقصة تأبيد لآلامي/ لست طبلاً، أنا منجم صداع”./ أخيراً/ أريد منك تفسيراً لمعنى الشكّ/ وتفسيراً آخر للخط الأبيض وراء السفن”.
بموازاة ذلك، نقف على شعريّة الاقتراب من اليومي والعابر والتفاصيل والأشياء العادية، البسيطة لكن العميقة، بشكلٍ يشفُّ عن علم جمال اليومي، عبر تصويره وشخصنته والهزء منه على نحوٍ لَوْذعيّ، كما لدى عزيز أزغاي، عبد الجواد العوفير، نعيمة فنو وعبد العالي دمياني. ونجد عند بعضهم معرفة لافتة بطرائق شعرنة اللغة داخل النثر، في استخدام اللغة الشعرية بشفافية عالية وتكثيف مجازي لافت، كما لدى حسن الوزاني، محمود عبد الغني، محمّد أحمد بنيس، نبيل منصر، كمال أخلاقي وعبد الجواد الخنيفي. يكتب منصر: “أنا اليوم أوهى من نملة تجرّ الحياة كجرادةٍ أكبر من بيتها. أقلّ ما يُشاع عني أني خسرتُ في الرهان ثورا مجنّحًا، ومالت في بحيرتي ظلالٌ بلا أجساد تمشي على الأرض./ في لحظات العطالة/ أكسر فخّار الأيام الأولى/ لأصنع طمْياً/ يصلح لعبث اليدَيْن”.
ونجد لدى آخرين انفتاحاً على أسلوب السرد وحوارات، ما يطلق طاقات اللغة التعبيرية في أناشيد حبّ أو قصائد توقيعات تقترب من القصيدة الرومانسية، أو قصيدة الومضة، أو الهايكو، أو الحكاية الرمزية، كما لدى عبد الرحيم الخصّار، إيمان الخطابي وعبد الله المتقي. يكتب عبد الرحيم الخصّار: “أنا نؤوم وذو همّة خاملة، لكني سألتقيك يومًا ما في قطار باليابان، سأجلس هادئًا في المقصورة وأرهف حواسي لألمح طائر البكاسين يرتفع خارجاً من قصيدة شيكو ولأسمع الأجراس تهز معبد أساكوسا وراء ضباب زهور الكرز”.
التفعيليون أيضا
لكن، ثمّة أيضَا تطوير دؤوب لجماليات شعر التفعيلة: الطاقة الإيقاعية الخلاقة التي تعكسها المرونة في الشكل والانتقال بين كتله الإيقاعية، عبر استثمار آليّات التقفية والتدوير والترجيع، كما لدى محمّد شيكي، محمّد بشكار، مصطفى ملح، محمّد عريج وأحمد الحريشي. يكتب عريج: “أجفُّ/ كَعِطْرٍ سرى في الهواءِ./ ولم يختبئْ في زوايا رئَةْ/ كضوءِ مَرايا بلا زائرينَ/ تنادي على أعينٍ مُطْفَأةْ/ كحرفٍ يتيمٍ على دِفْتَرٍ/ أبتْ إصبعُ الطّفل أن تقرأهْ/ كمعنى الشّتاء لبنتٍ تنامُ/ وتحرسُ أحلامها مِدْفأةْ/ كقلبي:/ هوى كسعال المناديل أرضاً/ ولم تَلْتَقِطْهُ امرأةْ..!”. ويكتب مصطفى ملح: “العِباراتُ لَمْ تَكْفِني لأَقولَ أُحِبُّكِ. تَلْزَمُني لُغَةٌ غَيْرُ مَحْروثَةٍ ولِسانٌ بِسَبْعِ لُغاتٍ.. وأَذْكُرُ / يَوْمَ الْتَقَيْنا بِبابِ المُدَرَّجِ في حِصَّةِ الأَدَبِ العَرَبِيِّ، وكَيْفَ نَسيتُ يَدي تَتَسَلَّلُ نَحْوَ يَدَيْكِ، / وكانَ الرِّفاقُ بِمُنْتَصَفِ السّاحَةِ المُسْتَطيلَةِ يَشْتَعِلونَ ويَنْطَفِئُونَ، وحينَ نَعودُ إلى الحَيِّ / أَنْسى بِثَوْبِكِ قَلْبي، وفي السَّكَنِ الجامِعِيِّ أَزورُكِ؛ أَبْني سَماءً وتَبْنينَ هاوِيَةً. ومَضَتْ / سَنَواتٌ.. مَشَيْتِ بَعيداً مَشَيْتُ بَعيداً.. ولَكِنَّ قَلْبيَ لَمْ أَسْتَرِدَّهُ بَعْدُ. سَتَلْزَمُني لُغَةٌ غَيْرُ/ مَحْروثَةٍ لأَقولَ: حَزِنْتُ كَثيراً، سَهِرَتُ كَثيراً، بكَيْتُ كَثيراً.. وقَسَّمْتُ عُمْري مُناصَفَةً: / للقَصيدَةِ شَطْرٌ، وشَطْرٌ لآخِرِ حُبّْ..”.
وهناك من سعى إلى استثمار عناصر الإيقاع، عبر إيجاد صيغ إيقاعية أخرى لا تقوم بديلًا للتفعيلة، بل تنشأ إمّا بالمزج بين الوزن والنثر(محمّد أنوار، محمّد وجمال الموساوي) أو تنبع من صميم البناء النثري وعفويّته كالتكرار والتوازي (أمل الأخضر ومحمّد العربي غجو). ثمّة كتابة أشبه بالهمس يصاحبها نزوعٌ إلى اقتصاد اللغة وتبئير أبعادها الدلالية، كما لدى سعد سرحان، سعيد السوقايلي، لبنى المانوزي ونزار كربوط. يكتب السوقايلي: “لقد مرّوا يا أبي، مرّوا بمحافظ ثخينة، ولم ألحق بهم، مرّوا خفافًا وصاروا جنرالات ومجرمين…كلّ ما في الأمر يا أبي، أني بقيت هناك، إذ ثمّة سلحفاة لم تعبر بعد إلى الضفة الأخرى”.
وثمّة عند آخرين انشغالٌ بالبعد الصوفي أو الروحي في الشعر من خلال التناصّ مع الآيات القرآنية وأقوال المتصوفة، كما لدى لطيفة المسكيني، جمال بوطيب، الزبير خياط وأمجد مجدوب رشيد. فعبر إشراقات السكر وخدره اللذيذ، تكتب لطيفة المسكيني: “من سكري ما صحوتُ/ جنّتني ريشة الصراخ صمتُّ/ جنّني ريح الصمت صرخت/ جنّني وصف الصوت حضرت في المعاني وغبّ/ جنتني الرؤيا شفعتها في وانصرفت/ يا رضا الصراخ في الصمت”.
نجد لدى الشاعرات اهتمامٌ بالجسد وافتتانٌ بالأنثوي والهشّ بلا ابتذالٍ أو إسفاف، داخل صيغ أسلوبية تتأرجح بين الإشراقي والرومانسي والذِّهني، كما لدى وداد بنموسى، فاطمة الزهراء بنّيس، إكرام عبدي، ريم نجمي، مليكة معطاوي. تكتب بنموسى: “خَذَلَتْني قُواي/ سقطتُ على/ رغوة حُبٍّ/ أوّاهُ من نُوره/ لفرطه/ أبصرتُني/ ملء/ عماي”. وتكتب فاطمة الزهراء بنيس: “لِهَوْلِ ما رشفْتُ/ تَجمّرتْ شفتايَ/ هبني يا قِبْلة الروح/ ليلة قمراء/ أنغمسُ فيها/ حدّ التجلِّي/ كيف أَبْقى/ في ضوء/ خذلَ أُنْثايَ؟”. وتقول علية الإدريسي البوزيدي: “إن لم يكن عندي نبيذ/ فعندك حانتي/ لتمارس/ إذن/ غيبوبتك”.
وأخيرًا لا بدّ من زيارة طائفة الشعراء التي ارتبط “وجودها الشعري” بالفيسبوك، التي لا مرجع لها في الكتابة إلا الذّات فقط. الذّات المتشظّية، لكن المنفعلة والمركّبة التي تشي بهشاشتها، وتطفح بصوتها الحميم وتنزع نحو اللا مرئي والمجهول، وقد ولّت ظهرها للمعضلات الكبرى مثل عبد الرحيم الصايل، سكينة حبيب الله، محمّد بنميلود، سناء عادل ونادية العناية. تكتب سناء عادل: “في النّهار أشتغل حفّارة قبور للأخطاء/ وفي الليل مربّية متفانية لليأس/ أُرضِع القلق وأهدهد الأرق/ لا هذا يشبع ولا ذاك يغفو/ وأخطائي لا تجيد شيئاً غير التّكاثر”. ويكتب عبد الرحيم الصايل: “أعملُ/ خريفًا/ يدرس الأزهار/ التي تمّ انتقاؤها/ أن أجمل الأزهار/ قد ماتت/ وأن الغابة الواقفة هناك/ هي صلاة جنازة أُقيمت من أجلها”.
فهذه الجماليات المغربية الجديدة متنوّعة، ومركّبة، ومتقاطعة تشمل الشكل والمحتوى؛ هي لا تخصّ قصيدة النثر التي استحوذت على أغلب شعراء الحساسية الجديدة، بل تنعكس في شعر التفعيلة التي لاحت وكأنّها تودّع طوراً وتستقبل آخر يعبّر عن رغبتها في التجديد.
العربي الجديد